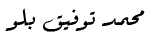-
يوم الموسيقى العالمي والغياب العربي

احتفل العالم بيوم الموسيقى العالمي (الاثنين 21 يونيو 2021م) الذي يتزامن سنويًا مع أول يوم لدخول فصل الصيف. وهو يوم خصص للاحتفال بالموسيقى أيًا كان نوعها ومدى تأثيرها على حياة الناس. بهدف تشجيع الموسيقيين الهواة والمحترفين على العزف والغناء في الشوارع، وملئ المناطق العامة بالموسيقى الحية، وصناعة الموسيقى التشاركية بين العازفين، وجعل جميع أنواع الموسيقى في متناول الجمهور من خلال تنظيم العديد من الحفلات الموسيقية المجانية على مدار اليوم.
وكانت أول احتفالية للموسيقى قد أقيمت في باريس عام 1982 تحت اسم Fête de la Musique أو اصنع موسيقى ليتحول بعدها هذا الاحتفاء بالموسيقى إلى ظاهرة عالمية. ويعود الفضل في ذلك إلى كلا من جاك لانج وزير الثقافة الفرنسي السابق، وموريس فلوريه مدير قسم الموسيقى والرقص الراحل في وزارة الثقافة الفرنسية. الذي كان لديه قناعة هي “موسيقى في كل مكان، وحفل في أي مكان”.
وقد احتفلت به هذا العام أكثر من 700 مدينة في 120 دولة حول العالم منها فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، ألمانيا، اليابان، الصين، روسيا، البرازيل، بيرو، المكسيك، اليونان، الإكوادور.
ولوحظ محدودية احتفال وزارات الثقافة والمجتمعات العربية بهذا اليوم رغم أن العرب وموسيقاهم هم أساس من قدم للعالم فنون وعلوم الموسيقى وآلاتها، فقد قال الجاحظ: “الموسيقى كانت بنظر الفرس أدبًا وبنظر الروم فلسفة، أما بنظر العرب فأصبحت علمًا”. وكان «سعيد بن مسجح المَكيّ» الذي شهد العهد الأموي أول من وضع السلم الموسيقي.
وأورد المؤرخ محمد يوسف طرابلسي في كتابه (جدة.. حكاية مدينة) قول استاذ الاسبانية بجامعة كابمريدج المهتم بتاريخ الموسيقى الاسبانية «جون براندي تريند» المولود في أواخر القرن التاسع عشر “إن كثيرًا من الآلات الموسيقية وردت إلى اسبانيا ومنها إلى أوربا على ايد المسلمين ولا يزال اسمها عربيًا. فالعود والقيثارة والربابة لا زالت أسماءها عربية. كما يوجد آلات أسماؤها مشتقة من الأسماء العربية”.
والواقع إن الموسيقى أحد الأدوات الجمالية والتربوية والثقافية التي تعمل على تقريب الشعوب والتواصل فيما بينهم. فقد قال عنها الموسيقار السعودي طارق عبد الحكيم – رحمه الله – “الموسيقى فن يجمع بين تشعُّبات العلوم الصحيحة وبين دروب الإِبداع الفكري والفني، ويتميز عنها جميعًا بأنه فن العقل والعاطفة، وفن التعبير الجماعي عند مختلف الشعوب، وفن الخصوصية والشمول في نفس الوقت”. واعتبرها الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه مقياسًا لمستوى حضارة الشعوب بقوله “إذا أردت الحكم على مستوى شعب ما فاستمع إلى موسيقاه”.
وقد أدرك العالم في عصرنا أهمية الموسيقى وضرورة الاحتفاء بها واختار منها “موسيقى الجاز” التي حددت لها منظمة اليونسكو يوما دوليًا للاحتفال بها في 30 أبريل من كل عام اعترافًا بقوة هذه الموسيقى من أجل السلام والحوار والتفاهم المتبادل، وقالت عنها نجمة الجاز الراحلة «نينا سيمون» “إن موسيقى الجاز موسيقى ليست مجرّد عادية، بل هي طريقة حياة وطريقة وجود وطريقة تفكير”. ومع ذلك أيضا لم تحظ احتفالية اليوم الدولي لموسيقى الجاز بالاهتمام العربي رغم ارتباط جذورها بعالمنا عبر القارة الأفريقية.
والحقيقة إن الموسيقى في عصرنا لا تقتصر على أنها مجرد فن للتقريب بين الشعوب، بل أحد أهم الموارد الاقتصادية الهامة غير المستثمرة في علمنا العربي كما يجب إذ أظهر تقرير الموسيقى العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للصناعة الفونوغرافية «IFPI» في 26/03/2021م أن إجمالي إيرادات صناعة الموسيقى للعام 2020م في أعلى 10 دول (الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، كوريا الجنوبية، الصين، كندا، استراليا، هولندا)، قد بلغ 21.6 مليار دولار أمريكي، ويلاحظ أن القائمة لم تضم أي دولة عربية ولعل ذلك يعود إلى عدم انتشار الموسيقى العربية عالميًا، وعدم وجود فنانين عرب يتقنون أداء فن الجاز بأداء عالمي باستثناء الفنانة القديرة فيروز والموسيقار عمر خيرت وقليل أخرون هنا وهناك.
ولابد من التنويه والإشادة بإدراك وزارة الثقافة السعودية بأهمية الموسيقى بتأسيسها هيئة للموسيقى السعودية برئاسة الأكاديمية والموسيقية جهاد الخالدي. لتطوير القطاع الموسيقي في المملكة من خلال دعم الأفراد والمؤسسات والشركات الموسيقية، وتشجيع إنتاج وتطوير المحتوى، بالإضافة إلى المهام التنظيمية والتشريعية المتعددة المتعلقة ببناء منظومة القطاع وبيئته الداعمة للحراك الموسيقي المحلي بما يضمن تأهيل المواهب وتمكينها، وتوفير برامج تدريبية وتشجيع التمويل والاستثمار.
وأرى أن تنطلق هذه الخطوة من الجذور والاصالة للموسيقى السعودية حتى تحتفظ بهويتها كواجهة حضارية للمجتمع، بتكوين فرقة أو فرقتين وطنية تضم عازفي بوقيات ووتريات وإيقاعات وآلات كهربائية والكترونية بالإضافة إلى البيانو بالاستعانة بالعازفين العسكريين المتقاعدين لإلمامهم بالنوتة الموسيقية وتنوع تخصصاتهم أسوة بما قام به الأديب طاهر زمخشري والموسيقار طارق عبد الحكيم رحمهما الله عند تكوينهم أول فرقة نظامية للإذاعة في خمسينيات القرن الميلادي التي بها انطلقت وتطورت الموسيقى السعودية المعاصرة، الاستعانة بمؤلفي الموسيقى لكتابة الفنون والفلكلور الموسيقي الموروث في بلادنا لتحويلها إلى معزوفات موسيقية عالمية، إعداد برامج إذاعية وتلفزيونية عن الموسيقى أسوة بالبرنامج الذي أعده وقدمه الموسيقار غازي علي للإذاعة السعودية في سبعينيات القرن الماضي لتثقيف الجمهور بالموسيقى المحلية والعالمية، كتابة السير الذاتية لرواد الموسيقى السعوديين الأحياء منهم والأموات للاستفادة من تجاربهم وإلهام الهواة بهم كالموسيقار مطلق الذيابي، عمر كدرس، سامي إحسان، سراج عمر، محمد شفيق رحمهم الله بالإضافة إلى الموسيقار غازي علي، عبده مزيد…الخ، وإنشاء معاهد لتعليم الموسيقى في عامة مدن المملكة مع إضافة برامج لتطوير الكوادر المساندة للصناعة الموسيقية مثل الهندسة الصوتية، البرمجة والمزج، الانتاج والإخراج والترويج والتسويق. واختم دردشتي هذه بأبيات من قصيدة «عازف العود» للدكتور محمود السيد الدغيم
دَنْدِنْ!! فَعُوْدُكَ طَيْرٌ بَيْنَ أَطْيَاْرِ
يُشَنِّفُ السَّمْعَ!! جَلَّتْ قُدْرَةُ الْبَاْرِيْ
فَصَاْرَ لَحْنُكَ إِنْشَاْداً لأَفْئِدَةٍ
هَاْجَتْ؛ وَمَاْجَتْ عَلَىْ أَلْحَاْنِ أَوْتَاْرِ
كَأَنَّهُ جَوْقَةٌ طَاْبَتْ مَعَاْزِفُهَاْ
فِيْ لَيْلَةٍ ذَاْتِ أَنْغَاْمٍ وَأَنْوَاْرِ
لَوْ أَنَّ زِرْيَاْبَ وَاْفَاْنَاْ؛ وَجَاْلَسَنَاْ
لَقَبَّلَ الْعُوْدَ جّهْراً دُوْنَ إِسْرَاْرِ
وَقَاْلَ – لِلنَّاْسِ – أَقْوَاْلاً مُمَوْسَقَةً
لِلْعَاْزِفِيْنَ عَلَىْ عُوْدٍ وَغِيْتَاْرِ
يَاْ أَيُّهَا النَّاْسُ!! هَذَا الْعَزْفُ؛ فَاسْتَرِقُوْا
سَمْعَ الْمَقَاْمَاْتِ مِنْ ذَا الْجَدْوَلِ الْجَاْرِيْ
فَفِي التَّقَاْسِيْمِ إِحْيَاْءٌ لِمَكْرُمَةٍ
كَاْدَتْ تَمُوْتُ بِعَهْدِ الذُّلِ وَالْعَاْرِ
-
الاثنينية وخوجة.. في ذاكرتي

عندما كنت أعد مقالي الذي نشرته الأسبوع الماضي «عشر سنوات على مقام حجاز ووفاة صاحبها محمد صادق دياب» https://garbnews.net/news/s/193547. رجعت كعادتي في البحث وجمع المعلومات إلى موقعي المفضل الأول (الاثنينية) لاستطلاع معلومات عما إذا كان دياب قد كرم فيها، والتزود بأي معلومات إضافية عنه، ففوجئت بأن الموقع غير متاح!، واظهرت نتاج البحث تفاعلات لحسابات المهتمين بالموقع جلها تأسف على توقف الخدمة فيه من أبريل 2021م، منهم المخرج والمنتج السينمائي محمود صباغ الذي قال في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر “تأسفت كثيرا من تعطل الموقع الالكتروني “للإثنينية”. من زمن باكر اخذ عبد المقصود خوجة ع عاتقه نشر أدب الرواد ورعاية مواسم الأدب. موقع الإثنينية مكتبة رقمية للأدب السعودي والذاكرة السياسية والاجتماعية. أعظم تكريم يستحقه منا الشيخ عبد المقصود هو توفير اللازم لإستمرار مؤسسة “الاثنينية””.
فأحزنني ذلك كثيرًا، لأن الموقع كان عبارة عن مكتبة ثقافية رقمية ضمت 178 مجلدا من إصدارات الاثنينية وأكثر من 33 ألف صورة توثيقية، إلى جانب 500 مادة مرئية لأمسيات التكريم على قناة الاثنينية على «يوتيوب» وحساب على الفيس بوك وتويتر وبث مباشر لحفلات التكريم، التي كانت تتم مساء كل اثنين بدارة مؤسسها الشيخ عبد المقصود خوجة طوال العام باستثناء الإجازة الصيفية بحضور رجال الفكر والصحافة والأدب من داخل المملكة وخارجها للاحتفاء بأحد رموز الشعر والأدب الذين أثروا الساحة ثم توسعت لتشمل رجالات الأدب والثقافة والعلم والفكر وغيرهم من المبدعين من مختلف أنحاء الوطن العربي. وكان أول من احتفي به الأديب والمؤرخ عبد القدوس الأنصاري في انطلاقة الاثنينية «22/01/1403هـ – 08/11/1982م».
وقد ارتبطت الاثنينية وصاحبها بذاكرتي منذ بدأت في مشروع كتابة السيرة الذاتية لجدي الأديب الراحل طاهر زمخشري في مطلع الألفية الثانية، حينما كاتبت كل من عرفت أن له علاقة به لجمع معلومات عنه، وكان من بينهم الشيخ عبد المقصود خوجة الذي ربطته به علاقة وثيقة ومن أكبر الداعمين له اجتماعيًا وأدبيُا، فأكرمني بنسخة من الجزئين الأول والثاني للاثنينية فكانتا بمثابة كنز أدبي لا يقدر بثمن ومرجع هام استندت إليه في تأليف كتابي “الماسة السمراء بابا طاهر زمخشري القرني العشرين الذي أصدرته في العام 2005م.
ثم جمعتني الصدفة للالتقاء المباشر به لأول مرة حينما زار مقر جمعية إبصار الخيرية في 31/08/2013م إبان إدارتي لها، وتعارفنا وأضافني إلى قائمة ضيوف الاثنينية، ومن حينها أصبحت اتردد عليها ومن المداومين على حضورها، وانبهرت جدًا بها وبطريقة تنظيمها وفي كل شيء مرتبط بها من حيث استقبال الضيوف من المتطوعين على رأسهم صاحبها شخصيًا. وإدارة الندوة من قبل اللجنة المنظمة وكلمة صاحب الاثنينية التي يفتتح بها اللقاء، ثم كلمة المكرم والخدمات التي توفر له من شرائح عرض وغير ذلك، وتنظيم جلوس النساء حيث لم يكن معتاد في تلك الفترة حضورهن في مثل هذه الأمسيات. وطريقة إدارة الأسئلة والحوار والنقاش المفتوح عقب كلمة المكرم، وطبيعة جائزة التكريم التي كانت رمزية ذات قيمة معنوية كمصاحف مخطوطة، أو قطعة من كسوة الكعبة وما شابه ذلك. وتختم الأمسية بمأدبة عشاء بنكهة شرقية كل ذلك يتم على خلفية صوت خرير المياه المنبعث من النوافير الموزعة في فناء المنزل، فيعطيك إيحاء وكأن بك في أحد مجالس الأدب في العصر الاندلسي.
وعلى ضوء لقاءاتي به والحديث معه عن بابا طاهر ووضع دواوينه وأعماله الأدبية بادر بإعلان قيام منتدى الإثنينية بجمع وإعادة طباعة دواوين الزمخشري الشعرية وكافة أعماله الأخرى. ونشرها ضمن مجموعة مطبوعات كاملة وتوزيعها ضمن إطار عمل الاثنينية الثقافي في جمع إرث المفكرين والأدباء الذين أثروا الساحة الأدبية السعودية المعاصرة. وبالفعل أوفد سكرتير الاثنينية د. محمد الحسن وشرعنا بجمع ما بحوزتي من مقتنيات أدبية للأديب، ولكن ظروف مرض الشيخ عبد المقصود وتوقف الاثنينية حالا دون استكمال المشروع.
ولا أنسى تلك الليلة المميزة من أمسية الاثنينية (416) «26/01/1434هـ» التي احتفي فيها بالبروفسيور د. زهير يوسف الهليس كبير استشاري جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، رئيس جمعية جراحة قلب الاطفال العالمية نظير إنجازاته المحلية والدولية، الذي جمعتني به ذكرى إنسانية حينما أجرى عملية جراحة قلب مفتوح لابني سندس بعد عشرة أيام من ولادته في 25 أكتوبر 1992م استمرت لمدة 8 ساعات ساهمت بفضل الله في انقاذ حياته. وأجرى له عملية قلب مفتوح أخرى بعد عامين من العملية الأولى. وكنت قد اصطحبت معي ابني سندس إلى تلك الأمسية لجمعه بالطبيب الذي أنقذ حياته وهو في المهد، فكان لقاء مثير بعد تعريفي له بنفسي وابني سندس وتذكيره بالعملية بعد 24 عام من إجرائها.
وبالعودة إلى موقع الاثنينية الإلكتروني فإنني أناشد نجله الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود خوجة بالعمل على إعادة إطلاق الموقع ليستعيد مكانته كمرجع معلوماتي متفرد عن الشخصيات التي كرمت وموسوعة أدبية موثقة من أفواه أصحابها، كما كان عليه بمثابة شمعة تضيء الطريق للباحثين والمهتمين بتراجم أعلام الشعر والأدب والفكر في الوطن العربي، كما أضم صوتي إلى النخب التي اقترحت ان يتم تطوير الاثنينية لتكون مركز ومنتدى ثقافي أدبي باسم مؤسسها للحفاظ على ذكراه وجهوده التي بذلها. وأن يكون للمركز مجلس إدارة وإدارة تنفيذية تقوم بوضع خطط العمل والإشراف على إدارة النشاطات الثقافية والفكرية فيه بالتعاون مع وزارة الثقافة والجهات المعنية كالأندية الأدبية وجمعيات الثقافة والفنون. واختم دردشتي بجميل ما قاله الشاعر خالد المحاميد مدحا بالشيخ عبد المقصود خوجة.
يا سيدي والقول فيك رواية
كتبت عظيم فصولها الأفعال
إن كنت أخفيت المكارم زاهدًا
فلها لسان فاضح ومقال
-
دردشات الصومعة: تهذيب مكبرات الصوت في المساجد

تابعت آراء مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بشأن قرار معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ (11/10/1442هـ) بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت، وذلك لما تحدثه هذه المكبرات من ضرر على المرضى وكبار السن والأطفال في البيوت المجاورة للمساجد، إضافة إلى تداخل أصوات الأئمة وما يترتب على ذلك من تشويش على المصلين في المساجد والبيوت.
والواقع إن هذه مشكلة عامة قد تنساق على العديد من الدول العربية والإسلامية واضيف إليها ما تحدثه من شوشرة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أثناء مشيهم في محيط المساجد أو داخلها فتعيق حركتهم باستقلالية، فأنا من ذوي الإعاقة البصرية المجاورين لمسجد وارتفاع مكبرات الصوت يشتت تركيزي في المشي، وحتى سماع من يريد مساعدتي وإرشادي مهما قربت مسافته مني.
وأعتقد أن استخدام مكبرات الصوت في المساجد بتلك الطريقة المبالغ فيها حرمت المحيطين بالمساجد من الاستماع إلى القرآن الكريم والانتفاع بما فيه من فوائد وأثر روحاني. بموجب ذلك القرار. فالطريقة التي اعتادت عليها غالبية مساجدنا منذ زمن بعيد في استخدام مكبرات الصوت هي المشكلة وليس صوت القراءة في الصلوات الجهرية بحد ذاتها، فهم اعتادوا على رفع الصوت بشكل مبالغ فيه وهذا منافي لتعاليم ديننا لقوله تعالى ﴿وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ لقمان (19) وهذه الآية مطلقة الدلالة بوجوب خفض الصوت والأخذ بالوسطية والاعتدال فيه أمر ضروري خصوصاً في الصلاة لقوله تعالى ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا﴾ الإسراء (110). والاستماع لصوت القراءة في الصلوات أمر محمود، فقد روى أبو داود بسند صحيح عن عبدالله بن زمعة رضي الله عنه قال «لما استُعِزَّ برسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وأنا عندَه في نفرٍ مِن المسلمين، دعاه بلالٌ إلى الصلاةِ، فقال: مروا مَن يصلي للناسِ، فخرج عبدُ اللهِ بنُ زَمْعَةَ، فإذا عمرُ في الناسِ، وكان أبو بكر غائبًا، فقلتُ: يا عمرُ، قمْ فصلِّ بالناسِ، فتقدَّمَ فكبَّرَ، فلما سَمِعَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صوتَه، وكان عمرُ رجلًا مُجْهِرًا؛ قال: فأين أبو بكرٍ؟ يأبى اللهُ ذلك والمسلمون! يأبى اللهُ ذلك والمسلمون! فبعثَ إلى أبي بكرٍ، فجاء بعدَ أن صلى عمرُ تلك الصلاةَ فصلَّى بالناسِ». واستنبط من ذلك إن صوت القراءة كان يصل إلى حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتأذ منه رغم مرضه الشديد إنما عارض صلاة عمر بالناس بدلاً من أبي بكر.
والحقيقة إن سماع القراءة أثناء الصلاة لها وقعها وأثرها على النفس البشرية حتى لغير المسلمين، خصوصاً عندما يقرأ بصوت جيد واستخدام صوتيات بجودة عالية ومتقنة الاستخدام. فأذكر أنه إبان عملي في جمعية إبصار الخيرية، استضفنا هيئة علمية من الولايات المتحدة الأمريكية كان من بينهم دكتورة غير مسلمة متخصصة في الفلسفة وعلم النفس، اعتادت الاستيقاظ مبكرًا لممارسة التأمل، فأخبرتني بأنه لفت انتباهها وجذبها أصوات جميلة للصلوات المبكرة من المساجد، وأن لها شعور روحاني لم تستطع تفسيره. فشرحت لها أنها صلاة الفجر وتؤدى في مثل هذا الوقت من كل يوم، فأصبحت تحرص على ممارسة تأملاتها في هدوء وسكينة الفجر على أصوات المساجد.
كما كان لي تجربة أخرى في تسعينيات القرن الماضي أثناء إحدى رحلاتي إلى نيويورك إبان عملي في الخطوط السعودية حيث ذهبت إلى جامع المركز الثقافي الإسلامي بمنهاتن – نيويورك لأداء صلاة الجمعة برفقة صديق أمريكي كان حديث عهد بالإسلام، وأول ما لفت انتباهنا وأثار إعجاب صديقي الأمريكي هو جودة ونقاوة صوت الأذان والخطيب وقراءة القرآن من مكبرات الصوت الموزعة داخل وخارج المسجد وفي أعلى المأذنة، خصوصاً وأن صديقي كان من مؤديي فن الأوبرا، فقد كان الصوت موزعاً بإتقان واحترافية بحيث أينما تكون في المسجد يصلك صوت الإمام وكأنه بجانبك وبدرجة نقية جدًا خالية من الشوائب الهوائية وترددات الصوت. أما من الخارج فالصوت كان يصل في محيط المربع الخاص بالمسجد بصورة تعتقد وكأن الإمام يقف إلى جانبك. وحينها أدركت أن مساجدنا بحاجة إلى تطوير تشغيل واستخدام مكبرات الصوت بطريقة احترافية تجعلك تسمع قراءة القرآن بصورة نقية ومؤثرة على النفس.
ولعل في هذين المثالين دلالة على الأثر النفسي الذي يحدثه صوت القراءة عبر مكبرات الصوت في المساجد عندما يكون بجودة متقنة حتى وإن كان المستمعين من غير المسلمين أو المرضى أو كبار السن. وقد أدركت السلطات الألمانية ذلك حينما سمحت في ابريل 2020م لأول مرة في تاريخها، برفع الآذان بمكبرات الصوت خارج المساجد في نحو 80 مدينة بهدف نشر الطمأنينة، والتخفيف من “فوبيا كورونا” بين الناس الذين فُرض عليهم الحجر الصحي، فضلاً عن إن سماع قراءة القرآن في الصلوات عبر المآذن تعطي سمة متميزة للمجتمعات الإسلامية والجهر بها محمود لقوله تعالى وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (المزمل 4).
وأرى أنه من الأوفق تهذيب استخدام مكبرات الصوت في المساجد للتخلص من الضوضاء والضجيج التي تحدثها، والسماح باستخدامها أثناء الصلوات فقط دون الدروس والحلقات الخاصة التي تعقد أعقاب الصلوات وذلك من خلال:
- وضع قوانين تحدد المدى الأقصى لانتقال ووصول الصوت من المساجد إلى المحيط الخارجي عبر مكبرات الصوت، بمسافة تستهدف المحيطين بالمسجد دون تداخلها مع أصوات المساجد الأخرى. وأن تنساق تلك القوانين على عامة المرافق التي تستخدم مكبرات صوت أو سماعات كبيرة كالأسواق والمطاعم والملاهي.. الخ.
- التأكد من أن تجهيزات مكبرات الصوت في المساجد حديثة ومزودة بالمؤثرات الصوتية ذات القدرة على التحكم في الترددات وصدى الصوت والحدة وامتصاص الهواء والمغنطة من الميكرفونات. مع ضبط درجة تضخيم الصوت (البيز والتريبل) حسب صوت المؤذن/الإمام/الخطيب، وأن يكون الحد الأقصى لدرجة ارتفاع الصوت ما بين 50-70%.
- التأكد من أن عدد السماعات الداخلية مناسب لحجم المسجد وموزعة بطريقة صحيحة، واتجاهها من الأمام إلى الخلف عكس المحراب بزاوية انحرافيه، مع وضع سماعة أو سماعتين داخل المحراب موجهة إلى الأمام مباشرة بتحكم مستقل عن باقي السماعات. ووضع مكبرات الصوت الخارجية في أعلى نقطة من المنارة مع توجيهها إلى الأعلى 70 درجة تفاديًا لاصطدام الصوت بالمباني الخرسانية الذي يتسبب في الصدى والضجيج.
- تأهيل وتوظيف كوادر وطنية في مجالات الهندسة الصوتية لمتابعة وتطوير وتشغيل الصوتيات لعامة المساجد. مع تقديم دورات تدريبية في مهارة استخدام مكبرات الصوت والصوتيات في المساجد للأئمة والمؤذنين والقائمين على تشغيلها.
- متابعة تنمية وتطوير التجهيزات الصوتية للمساجد بصورة دورية. واستخدام هندسة تقنية الصوتيات المستخدمة في الحرمين كمرجع يقتدى به في عامة المساجد.
وعلى أية حال إن صوت قراءة القرآن من المآذن سمة تميز المدن الإسلامية ولها وقعها وأثرها الروحاني على النفوس، كما لأجراس الكنائس من سمة للمدن المسيحيةـ وأختم دردشتي بما قاله الدكتور عبد الحميد أبو سعده في قصيدته «القرآن.. يا أمة القرآن»:
يَا أُمَّةَ القُرْآنِ إِنَّ كِتَابَكُمْ لَهُوَ الشِّفَاءُ وَصِحَّةُ الأَبْدَانِ
وَهُوَ الدَّوَاءُ لِكُلِّ جُرْحٍ غَائِرٍ وَهُوَ المُحَارِبُ نَزْغَةَ الشَّيْطَانِ
وَهُوَ البَلاَغَةُ وَالفَصَاحَةُ كُلُّهَا وَهُوَ الحَضَارَةُ فِي عُلُوِّ مَكَانِ
فَهُوَ الخِطَابُ لِكُلِّ عَقْلٍ نَابِهٍ وَهُوَ الضِّيَاءُ بِنُورِهِ الرَّبَّانِي
يَهْدِي إِلَى الخَيْرِ العَمِيمِ وَإِنَّهُ أَمْنُ القُلُوبِ وَرَاحَةُ الأَبْدَانِ
-
سيف القدس والدروس المستفادة للأشخاص ذوي الإعاقة

تابعت مؤخراً باهتمام بالغ على شاشة التلفزيون مشهد لم أعهده من قبل وهو الخروج العفوي لجموع الجماهير الفلسطينية (أطفال، شباب، شيبان) إلى شوارع غزة ومدن الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، وعموم مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، في تمام الساعة الثانية من فجر الجمعة 21 مايو 2021م – 09 شوال 1442هـ، احتفالاً وابتهاجا بما اعتبروه انتصارًا للمقاومة الفلسطينية على الجيش الإسرائيلي في المعركة التي أطلقت عليها المقاومة “سيف القدس” بعدما أعلنت الحكومة الإسرائيلية وقفًا لإطلاق النار غير مشروط بوساطة مصرية لعمليتها العسكرية على غزة “حارس الأسوار” التي استمرت 11 يومًا وأودت بحياة أكثر من 243 فلسطينيا بينهم 66 طفلا، وإصابة أكثر من 1900 شخص. ومقتل 12 إسرائيلي وإصابة 335 شخص.
كما أفرحني كثيرًا الموقف المشرف لبلادنا المملكة العربية السعودية بترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتثمينها للجهود المصرية والأطراف الدولية الأخرى التي ساهمت في ذلك. وتطلعها إلى تضافر الجهود لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وتأكيدها على مواصلة مساعيها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق ذلك. بالإضافة إلى إدانتها وشجبها للاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما أسفر عنه من سقوط للضحايا الأبرياء والجرحى التي جاءت في اتصال هاتفي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالرئيس الفلسطيني محمود عباس (الجمعة 21 مايو 2021م – 09 شوال 1442هـ)، وأكد خلاله أن المملكة ستواصل جهودها على كافة الأصعدة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية على القدس، من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وتمنى للشعب الفلسطيني الأمن والسلام.
والحقيقة أن ذلك ليس بغريب على بلادنا، فالمملكة العربية السعودية تعتبر من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله وحتى يومنا هذا. ولها العديد من المواقف التاريخية الدالة على ذلك كإرسالها فرقة كاملة من الجيش السعودي وفتح باب التطوع للشعب للجهاد بجانب إخوانهم الفلسطينيين في حرب الـ 48، واقتراح الملك فيصل رحمه الله بإنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي) في أعقاب جريمة حرق المسجد الأقصى في العام 1969م. ومشاركتها في حرب أكتوبر 1973م ضمن الجبهة السورية في الجولان وتل مرعي. وحظر النفط على الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الأخرى التي دعمت إسرائيل في تلك الحرب، مما ساهم في انتصار العرب على إسرائيل.
ولعلي كنت من الأطفال المحظوظين الذين وعوا وأدركوا نشوة فرحة ذلك الانتصار، وهذا ما جعلني استشعر وأتابع فرح آلاف الشباب الفلسطينيين الذين خرجوا للاحتفال في باحات المسجد الأقصى وعامة الأراضي الفلسطينية فرحاً بـ “جمعة النصر”.
وأكثر ما أثار اهتمامي ودهشتي هو رباطة الجأش وقوة العزيمة والإرادة التي تحلى بها قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صاحب الإعاقة الحركية «محمد الضيف» ذو الـ 56 عام الذي فقد إحدى عينيه في سبتمبر 2002م، وذراعيه وساقيه في يوليو 2006م إثر محاولات اغتيال متكررة من قبل الموساد الإسرائيلي وهو لا يزال حتى الآن أحد أهم المطلوبين لديها بعد فشل محاولتين لاغتياله خلال العملية العسكرية الأخيرة وفق ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية على لسان المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي العميد “هيدي زيلبرمان” خلال حديثه مع الصحافيين.
ولعله استمد تلك العزيمة من نشأته الدينية بمخيم خان يونس وتعلقه بمساجدها “بلال، الشافعي، الرحمة”، وملهمه الشيخ أحمد ياسين صاحب الإعاقة الحركية الذي أصيب بشلل كلي في شبابه أثناء ممارسته للرياضة، مؤسس حركة حماس، وأكبر جامعة إسلامية في غزة، وأصبح أشهر خطيب مؤثر عرفه قطاع غزة خلال الاحتلال الاسرائيلي لها. وضاقت إسرائيل بنشاطاته ذرعاً فاعتقلته مرتين أخرهما في عام (1409هـ – 1989م) لمدى الحياة و15 عاماً أخرى لاتهامه بالتحريض على اختطاف وقتل جنود إسرائيليين وتأسيس حركة حماس. ثم أطلقت سراحه في عام 1417هـ-1997م في صفقة مع الأردن إرضاء لها بعد محاولة الموساد الفاشلة لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس آنذاك خالد مشعل على أرضها. وأخيرًا اغتالته في عملية بإشراف رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك ايريل شارون بإطلاق 3 صواريخ استهدفته وهو على كرسيه المتحرك بعد خروجه من مسجد المجمع بغزة عقب صلاة فجر الاثنين غرة صفر 1425هـ – 22 مارس 2004م
وفي كلتا الحالتين «الشيخ أحمد ياسين» و«الضيف» نموذج للأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية التحلي بالعزيمة والإصرار في سبيل تحقيق الأهداف مهما عظمت حتى لو أدت إلى التضحية بالأرواح للدفاع عن الأوطان. ولنا في الصحابي الكفيف عبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه الذي استشهد في معكرة القادسية أسوة حينما قال «أقيموني بين الصفين وحملوني اللواء أحمله لكم وأحفظه، فأنا أعمى لا أستطيع الفرار».
وبالعودة إلى موضوع “سيف القدس” أختم دردشتي بما قاله الأديب طاهر زمخشري رحمه الله بمناسبة انتصار حرب اكتوبر 1973م في قصيدته “يا ضمير الإنسان” التي مهرها بقوله “إلى الجندي العربي الباسل الذي شارك في حرب رمضان المبارك..!!”
يا ضمير الإنسان إن دمانا ** قد تلظت مسعورة في حمانا
تطلب الثأر صارخاً من طغاة*** دنسوا الأرض غدرة لا طعانا
وتباهوا بأنهم قد اصابوا *** ما أرادوا فالجموا خذلانا
نشهد الله والملائك أنا *** ما اندفعنا نريد من والانا
فمن القائد المظفر فينا *** اقتبسنا الإخلاص والإيمانا
فيصل العرب من حمى حوزة *** الدين بما في يمينه فافتدانا
-
فرسان الجو المغيبون في زمن كورونا

منذ عام بدأت بالكتابة عن جائحة كورونا بمقال بعنوان «الكورونا بين الصين وإيطاليا وكيف نجابهه» في 16/03/2020م https://garbnews.net/articles/s/4447 حينها كانت الجائحة في بداية انتشارها بإصابة 181,335 توفي منهم (7,130) وشفي (78,332) مصاب. وتابعت الكتابة عنها على مدى 9 أشهر بـ 31 مقال تناولت مواضيع مختلفة عن الجائحة طبية، اجتماعية، علمية، تعليمية، انسانية، اقتصادية مع رصد أسبوعي لإحصائيات الجائحة حول العالم (الإصابات/الوفيات) وأعلى ستة دول تضرراً. وما سجلته المملكة العربية السعودية، والتطرق للتحديات التي واجهت (احتفاليات المناسبات الدولية، وذوي الإعاقة والأنشطة الاقتصادية والخيرية وكوارث الطيران وقصص إنسانية أخرى).
ومع الوصول للقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) وبدء الدول في وضع الخطط لحملات التطعيم بإعطاء الأولية في اللقاحات للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في مرافق الرعاية طويلة الأجل والذين يتوقع أن العديد منهم يصنفون ضمن فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، توقفت تدريجياً عن الكتابة عنها.
وما لفت انتباهي هو غياب الإتيان على أي ذكر لقطاع الطيران المدني ضمن أوليات إعطاء اللقاحات والذين يتوقع أن عددهم بلغ وفق منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) 10مليون رجل وامرأة. أو أي ذكر لما قاموا به من أدوار أو تضحيات خلال الجائحة، رغم أهمية الدور الذي قاموا به لضمان الإمداد العالمي بالأدوية واللقاحات والمعونة الإنسانية وغير ذلك من السلع الحيوية. فراجعت كل ما كتبته عن الجائحة ووجدت أنني تناولت الدور الفعال الذي لعبته الكوادر (الطبية، الرياضيين، الفنانين، عمال النظافة، النبغاء، الأثرياء) في مواجهة الجائحة. وغفلت عن دور العاملين في مجال الطيران المدني من طيارين ومضيفين والعمال الأرضيين المساندين لهم. فأجريت بحثاً عما كتب عن دورهم في الجائحة وكل ما وجدته هو أخبار عن تسريحهم من أعمالهم بسبب الخسائر التي تكبدها قطاع الطيران نتيجة الجائحة.
فبدأت أتمعن في دورهم وما قاموا به خلال الجائحة فوجدت أنهم يستحقون أن يطلق عليهم “فرسان الجو في زمن الجائحة” فقد لعبوا دور هام جداً في الحد من الآثار الإنسانية والاجتماعية والطبية والاقتصادية وساهموا بإيصال المنتجات والأدوية اللازمة من وإلى الدول المحتاجة وقدموا تضحيات إنسانية أدت ببعضهم لفقدان حياتهم اثناء نقلهم أشخاص لبلدانهم تقطعت بهم السبل بسبب الجائحة كطاقم رحلة الخطوط الهندية «air india express» في رحلتها «IX-1344» (07 أغسطس 2020م) الذين فقدوا حياتهم في الطائرة التي كانت تقل 160 راكباً كانوا عالقين في دبي بسبب جائحة كورونا بعد انزلاقها من مدرج مطار كاليكوت بالهند وسقوطها في وادي وتحطمها ومصرع 162 من ركابها وطاقمها.
أو اضطرار بعضهم للسفر وترك أسرهم المصابين بالعدوى وانشغال فكرهم بهم اثناء الطيران مثل طياري رحلة الخطوط الباكستانية (PIA) رقم 320 (22 مايو 2020م) اللذين تأثرا نفسياً بإصابة عدد من ذويهم بالعدوى فانشغلا بالحديث عنهم خلال الهبوط مما أدى إلى ارتكابهما خطأ بشري نتج عنه ارتطام الطائرة بمباني سكنية بكراتشي ومصرع 97 شخص بمن فيهم الطاقم.
ومن قبلهما طاقم رحلة الخطوط الأوكرانية «PS752» على طائرتها «بوينغ 737» (8 يناير 2020م) التي تحطمت بعيد إقلاعها من مطار طهران في طريقها إلى مطار كييف. ولقي جميع من كان عليها من ملاحين وركاب مصرعهم
كما أن طبيعة عمل طاقم الطائرة لا يخلو من خطر الإصابة بالعدوى بسبب صعوبة التباعد الجسدي المطلوب في حالات التواجد في قمرة القيادة، أو اجراء اسعافات أولية في حالات التنفس الاصطناعي أو أي اسعافات أخرى تستدعي الملامسة المباشرة. ولا يعرف كم من طواقم الطائرات أو المساندين الارضيين قد أصيبوا بالعدوى أثناء تأدية عملهم.
والواقع إن طبيعة عمل الملاحين الجويين تستدعي التضحية الإنسانية مهما كانت الظروف والمخاطر، فعلى سبيل المثال استحضر من ذاكرتي ابان عملي كملاح جوي في العام 1985م كنا في طريقنا من جدة إلى نيويورك على رحلة الخطوط السعودية (021) على طائرة بوينج «368-B747» أصيبت مسافرة بارتفاع شديد في درجة الحرارة على الرحلة كادت تفقدها حياتها. فاستعنا بطبيب على الرحلة، فشخصها بأنها تعاني من الحمى الشوكية (التهاب السحايا المعدي) مما استدعانا على الفور لعزلها في مطبخ الطائرة، وتكميدها بالثلج واعطاها الطبيب حقنة لخفض حرارتها دون الاكتراث بالعدوى التي قد تصيبنا من أجل انقاذ حياتها، وهبطنا اضطرارياً في مطار أثينا لنقلها إلى المستشفى، ثم واصلنا رحلتنا إلى نيويورك، وعندما وصلنا تم حجرنا جميعاً في الطائرة لساعات واعطائنا لقاح مضاد للحمى الشوكية قبل مغادرتنا للطائرة.
والآن وقد اصابت الجائحة 136,159,923 في 219 بلد وإقليم حول العالم توفي منهم 2,941,490 أعلاها أمريكا بـ 31,869,996 إصابة توفي منهم 575,595، البرازيل 13,445,006 توفي 351,469، الهند 13,358,805 توفي 169,305، فرنسا 5,023,785 توفي 98,602، روسيا 4,641,390 توفي 102,986، بريطانيا 4,368,045 توفي 127,080 وسجلت المملكة العربية السعودية 398,435 حاله توفي منهم 6,754 وشفي منهم 383,321.
أدعو لإعطاء أولوية اللقاحات لعامة الملاحين وطواقم عمل المطارات. وتكريم اللذين قدموا منهم تضحيات إنسانية خلال الجائحة. مع اجراء البحوث والدراسات لأنجع الوسائل في تمكين الملاحين من القيام بأي إجراءات اسعافات أولية على الطائرات متى ما لزم مع توفر شروط الإجراءات الاحترازية اللازمة للحماية من العدوى.
واختم دردشتي هذه بلطيف ما قاله الأديب طاهر زمخشري رحمه الله في قصيدته «في الطائرة» “إلى الصديق..؟ الذي وجد نفسه طبيباً فأخذ يعالج الدوار الذي قعد بالمضيفة عن أداء عملها في الطائرة..!!”
عاشت يمينك يا آسي مضيفتنا إن الدواء الذي قدمتَ عطَّارُ
لما تهادت أفاضت من بشاشتها ما كان يرجوه ركاب وطيار
في جوف طير بلا ساق ولا قدم ولكنه في مدار النجم سيار
قالو «فلبينية» للشرق نسبتها وليس بدعا فكم في الشرق أقمار
مخارج الحروف فيها لكنة عجب في حلو منطقها نور ونوار
-
مصوع وأسمرة في ثقافتنا العربية

منذ أشهر وأنا أعمل مع الزميل الرحالة أمين غبره على كتابة رواية دارت أحداثها في أواخر ستينيات القرن الماضي بين جدة ومصوع وأسمرة بأرتيريا حينما كانت تحت حكم الامبراطورية الإثيوبية. وخلالها أدركت أن لتلك المدينتين عمق تاريخي وأواصر صلة اجتماعية وثقافية وتجارية ببلادنا منذ القدم كان الكثير منها غائباً عني رغم ارتباطها بتاريخنا الإسلامي وتراثنا الثقافي فـ «مصوع» التي عرفت أيضاً باسم «باضع» كانت مهبط أول هجرة في الإسلام وموقع لأول مسجد يبنى فيه.
ففي مثل هذا الشهر الهجري (رجب من العام الخامس للبعثة النبوية – 615م) خرج الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجراً إلى بلاد الحبشة ولحق بهما 11 رجل و3 نساء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر جدة فالشعيبة ومنها أبحروا إلى اليمن وعبروا إلى جزيرة «دهلك» واخيراً رسوا على شاطئ مصوع ثم السير برا إلى مدينة «كعبر» في بداية اقليم «أمهرة»، وعادوا إلى مكة في شهر شوال من نفس العام. فقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «خرج عثمان بن عفان مهاجرًا إلى أرضِ الحبشةِ ومعه رُقيَّةُ بنتُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم واحتَبَس على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم خبرُهم فكان يخرُجُ يتوكَّفُ عنهم الخبرَ فجاءَتْه امرأةٌ فأخبَرَتْه فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إنَّ عثمانَ لأوَّلُ مَن هاجَر إلى اللهِ بأهلِه بعدَ لوطٍ».
وفي العام التالي (6 للبعثة – 616م) هاجر إليها مرة أخرى 83 صحابي و19 صحابية بقيادة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه هرباً بدينهم من مشركي قريش. والتقوا بملكها «النجاشي» الذي استضافهم وأكرمهم وأعطاهم الأمان.
وكان الصحابة رضوان الله عليهم قد بنوا في هجرتهم الأولى أول مسجد في تاريخ الإسلام بـ«رأس مدر» عرف باسم «مسجد الصحابة»، ولا يزال موقعه قائماً حتى يومنا هذا بمنطقة ميناء «مصوع» بمحرابه الأساسي الذي كان باتجاه المسجد الأقصى. ومن حينها تجذر الإسلام في تلك البلاد وانتشر وارتبط أهلها بالعرب والمسلمين بمصاهرة ونسب وتبادل ثقافي وتجاري وأصبحت اللغة العربية من اللغات السائدة إلى جانب اللغات المحلية الأخرى التجرية والتغرينية والعفارية والساهو، والعرب أحد مكونات المجتمع إلى جانب الأعراق الأخرى كالكوناما والتجرينيا. ولا يزال الأهالي يقيمون صلوات الأعياد في مسجد الصحابة تيمناً بالمكان، وتخليداً لأول هجرة في الإسلام.
أما أسمرة التي بناها الإيطاليين في عام 1897م إبان حقبتهم الاستعمارية للبلاد وجعلوها عاصمة بدلاً من مصوع لموقعها الاستراتيجي الجبلي وجوها المعتدل وطبيعتها الخلابة بعدما أولوها عناية فائقة بإنشاء المباني الحديثة ودور العبادة والمستشفيات والطرق والسكة الحديدية والمطار والصرف الصحي الذي لم يكن له نظير في دول المنطقة لتكون بمثابة روما افريقيا. فلم يتخلف المسلمون من أهاليها وأهالي مصوع من الحفاظ على الجذور الإسلامية والثقافة العربية في تلك المدينة، وخير شاهد على ذلك «مسجد الخلفاء الراشدين» الذي بناه المعلم المعماري «عامر الجداوي» من أهالي مصوع في العام 1900م – 1319هـ إبان لجنته الأولى برئاسة كبير التجار «أحمد أفندي الغول» ذو الأصول المصرية، واستمر شامخاً على مر السنين رمزاً وشاهداً على عمق التاريخ الإسلامي والعربي فيها، وعمل المسلمون من الأهالي جيل بعد جيل على المساهمة في توسعته وتطويره ووقف الأوقاف له ووثق ذلك مفتي ارتريا الأول «الشيخ إبراهيم المختار أحمد عمر» – رحمه الله – في كتابه «القُنبرة في تاريخ المركز الإسلامي في أسمرة» وذكر منهم الشيخ حسن عبدالله بامشموش، أنجال سعيد عبدالله العمودي، الحاج حسان عبدالله اليماني، الأخوين عمر وسعيد سالم باعقيل، والحاج إبراهيم محمد حسين وغيرهم. وقال:
إن تفخر أرتريا بما في طيها *** فجامع أسمرة يكفيها فخرا
وقد امتدت تلك الجذور الاسلامية والعربية لعصرنا الحاضر فقد كانت أسمرة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي مقصد تجاري وثقافي وسياحي لأهالي جدة لازدهارها في ذلك الوقت خصوصاً في المجال الطبي إذ استقطب مستشفاها الايطالي ENAIL الأشهر والأضخم في المنطقة آنذاك أهالي جدة والمنطقة للعلاج فيه.
وبالعودة إلى الرواية التي خلصت منها بمدى العمق التاريخي والثقافي بيننا وبين مصوع وأسمرة بما في ذلك اللباس والأطعمة والكثير من العادات والتقاليد فعلى سبيل المثال نجد أن لباسهم الشعبي الذي يرتدونه في الأفراح والأعياد والجُمع هو الثوب الذي يسمى عرّاقي ويلبس عليه السديري والعمة الحلبية. وأشهر الأكلات الشعبية «أكّلَتْ» المعروفة عندنا بـ «العصيدة» و«المَاَدة/المضبي» و«المشكلة» وهي مجموعة ايدامات تضم «الزقني» و«الكمونية» و «العدس» تؤكل بخبز «الإنجيرة/الكسرة». وحتى فنونهم عرفت في بلادنا منذ العهد النبوي في المدينة المنورة فقد روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري «أنَّ أبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْه، دَخَلَ عَلَيْهَا، وعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ في أيَّامِ مِنًى تُغَنِّيَانِ، وتُدَفِّفَانِ، وتَضْرِبَانِ، والنبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُتَغَشٍّ بثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُما أبو بَكْرٍ، فَكَشَفَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن وجْهِهِ، فَقالَ: دَعْهُما يا أبَا بَكْرٍ، فإنَّهَا أيَّامُ عِيدٍ. وتِلْكَ الأيَّامُ أيَّامُ مِنًى. وَقالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَسْتُرُنِي، وأَنَا أنْظُرُ إلى الحَبَشَةِ، وهُمْ يَلْعَبُونَ في المَسْجِدِ، فَزَجَرَهُمْ فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: دَعْهُمْ، أمْنًا بَنِي أرْفِدَةَ يَعْنِي مِنَ الأمْنِ».
وبلاد الحبشة المذكورة هي ما يعرف اليوم بدولتي إثيوبيا وارتيريا، وعرفت بهذا الاسم نسبة إلى أحد قبائل حمير من اليمن تدعى «حبشت» هاجرت قبل القرن الخامس قبل الميلاد من اليمن إلى تلك البلاد وأقامت مملكة بها حاضرتها «اكسوم» وهي مدينة تاريخية تقع حالياً شمال إثيوبيا في إقليم التجراي.
وأدعو الكتاب والنخب المثقفة بالتنقيب عن الإرث الأدبي والفكري والثقافي العربي المتجذر في تلك البلاد خصوصاً أسمرة التي اختلطت فيها الثقافة الحبشية والعربية والايطالية، وإثراء ساحتنا الفكرية والأدبية والثقافية بها في ظل حركة التجديد الثقافي التي تعيشها بلادنا حاليًا واختم دردشتي هذه بما قاله الشيخ محمد فاضل التقلاوي في مدينة أسمرة:
على قمة العلياء تزهو وتخــلب *** وفـوق تليد المـجد شماء ترهـب
عروس الربى مجلوة تعشق العـلا *** فيهفـو لـها قلبي مليـا ويطـرب
منمقة حسنـاء تبـدو كأنهـــا على *** الفلك العلياء في الأرض كوكب
حبتها يـد الـزمان للفـن تحـفة *** وصورها عـات خـبير مجــرب
-
دردشات الصومعة: 57 مقالاً في ميزان عام

على ضوء ما وعدت به قراءنا الأعزاء في مقالي «بعد عام مع غرب» المنشور بتاريخ 2019/12/30 «https://garbnews.net/articles/s/4358» بأن أطل عليهم بزاوية بعنوان «دردشات الصومعة»، وأخرى «سطور مضيئة» عبارة عن قصص إنسانية لتجارب نجاح راجياً أن تكون هاتان الاطلالتان إضافة ثقافية ومساهمة مني في الحراك الأدبي والفكري والتوعوي المعاصر وفق رؤية المملكة 2030م.
فقد وفقني الله بأن انهي العام 2020م بـ 57 مقالاً حصدت 753,600 قراءة منها 16 مقال أدبي وثقافي، 14 اجتماعي، 11 صحي، 11 إعاقة، و5 إنساني، نشرت ضمن زاوية دردشات الصومعة، سطور مضيئة، كلام رمضان، واستحوذت جائحة كورونا على معظمها بـ 31 مقال سلطت من خلالها الضوء على أبعادها الصحية والاجتماعية والإنسانية والثقافية.
ولقياس مدى متابعة ورضى القراء عن تلك المقالات أجريت مؤخراً دراسة استطلاعية عبر شبكات التواصل الاجتماعي على عينة عشوائية من متابعي مقالاتي وهو إجراء بدأته منذ العام الماضي للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم لتطويرها.
شارك في الدراسة 63 شخص بزيادة «21%» عن العام المنصرم وهو مؤشر إيجابي لزيادة التفاعل مع المقالات وأظهرت النتائج أن %76.2 يتابعون مقالاتي بصفة مستمرة و %22.2 أحياناً و %1.6 لا يتابعونها.
وأن %82.5 يتابعونها عبر الواتساب، %20.6 تويتر، %6,3 فيسبوك، %1.6 بريد إلكتروني
وأن %50.8 من القراء يتابعون جميع المقالات، %42.9 دردشات الصومعة، %22.2 المقالات العامة، %15.9 سطور مضيئة
و%63.5 اعتبروا المواضيع الاجتماعية هي الأكثر إثارة للاهتمام، %57.1 الإعاقة، %49.2 الإنسانية، %41.3 الأدبية، %41.3 الصحية، %1.6 جميع المواضيع، 1.6% غير ذلك (لاسيما المتعلقة بالأديب الأستاذ طاهر زمخشري)
وأيد %82.5 ربط أبيات من الشعر العربي الفصيح بمواضيع دردشات الصومعة، و %14.3 لم يؤيدوا، %1.6 أن تكون بالفصحى والعامية، %1.6 لا مانع إذا كانت قليلة للاستشهاد والاستدلال.
وأيد %98.4 استمرارية كتابة سطور مضيئة التي تتناول قصص وتجارب نجاح متنوعة، بينما %1.6 لم يؤيدوا.
ورأى %67.9 بأن تكون المقالات أسبوعية، و %35.7 شهرية، وفضل %82.5 وصول المقالات إليهم عبر الواتساب، %20.6 تويتر، %6.3 فيسبوك، %1.6 بريد إلكتروني
واقترح عدد من المشاركين بأن تتناول المقالات المستقبلية المواضيع التالية
الإعاقة (أنواع الاعاقات، الاستقلال الذاتي وإعادة التأهيل، التقنيات المساندة، القوانين، قصص نجاح وتجارب تاريخية عالمية محلية، جهاد أولياء الأمور، لقاءات مع مختصين، أبحاث).
السلوك الاجتماعي (العمل الخيري، التعامل مع الآخرين، الاخلاق، الضمير، الحسد، البغضاء، الاتهامات، القيادة، النظافة، الشوارع والطرقات، السلوك العام)
مواضيع متنوعة (الاحداث والموضوعات العامة التي تمس المواطن وحياته، مستجدات الحياة الاجتماعية في ظل الظروف الآنية، آثار كرونا على حياة الناس، قادة المجتمع في المجالات المتعددة، الجديد من ذكريات الأديب طاهر زمخشري، تاريخ مكة واهلها، الفن والفنانين السعوديين، شخصيات بالتزامن مع ذكرى ميلادها أو وفاتها، لقاءات مع شخصيات ناجحة).
وعلى ضوء تلك النتائج فإنني أوجه شكري وتقديري للقراء الذين شاركوا في تلك الدراسة التي خلصت منها بأن المقالات كانت مرضية للقراء وأنها لبت رغباتهم وأثارت اهتمامهم، وأن وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة ناجعة لقياس مدى رضى القراء وزيادة اهتمامهم بالمواضيع التي تطرح في المقالات، فضلاً عن الاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم لطرح المواضيع التي تهمهم في ظل اتجاه الكثير لمنشورات التواصل الاجتماعي العامة كبديل عن المقالات الصحفية رغم أنها الأوثق قولاً، فهي بمثابة لسان البلاد ونبض العباد كما قال أمير الشعراء الذي اختم دردشتي هذه بقوله
لكلِّ زمانٍ مضى آيةٌ *** وآيةُ هذا الزمانِ الصُّحُف
لسانُ البلادِ، ونبضُ العباد *** وكهفُ الحقوق، وحربُ الجنَف
-
مأكولات حجازية ترتبط بأحوال الطقس

جدة منال الجعيد
فيما تشهد بعض مناطق المملكة بشكل عام، والمنطقة الغربية خصوصا أجواء ماطرة، ارتبطت بعض العادات والتقاليد الغذائية بأوقات معينة، كوقت هطول الأمطار وأوقات الشتاء والصيف، فاشتهر أهالي الحجاز بتناول المعدوس أثناء هطول الأمطار والاستمتاع به على شاطئ البحر.
ذاكرة قديمة
وفي هذا الصدد يقول الكاتب والمؤلف محمد توفيق بلو الذي بدأ حياته العملية في مجال الضيافة الجوية حتى أصبح طاهيا جويا ومدربا للطهاة، قبل أن يفقد بصره وينتقل للعمل في مجال خدمات الإعاقة البصرية: بعد طول غياب أمتعتنا الرحمة بأمطار جميلة لطيفة على عروس البحر جدة، فأسرعت إلى سطح منزلي للاستمتاع بها، فأعادت ذاكرتي إلى أكلة «المعدوس»، وهو الرز بالعدس يقدم مع الحوت الناشف أو السمك المقلي، وإن ضاق الوقت يتم طهي تونة مع الطماطم والبصل بدلا من السمك، ويحرص رب الأسرة الذي يمتلك سيارة بسباق الزمن إلى شط البحر للاستمتاع بها.
ويضيف بلو، أن هذه الأجواء الماطرة ذكرتني أيضًا بتخصصي القديم في مجال تجميل وعروض الطعام والطهي، فلطالما تمنيت تأليف كتاب عنها فمجتمعنا السعودي يزخر بقوائم غنية من الأطعمة والمأكولات المتنوعة التي غالبا ما ترتبط بالمواسم كرمضان والحج ويوم دخول السنة الهجرية الجديدة.
موروث منظم
وأبان بلو أن من يدرس العادات والتقاليد الغذائية في مجتمعنا سيلحظ أنها موروثة ومنظمة جدا، فهناك أكلات ومشروبات ساخنة وباردة، كل منها يعد ويؤكل أو يشرب في مواقيت معينة ومن الجميل الحفاظ عليها.
ففي مناسبات الأفراح غالبًا ما تكون ولائم الغداء والعشاء بأطباق الكوزي أو الزربيان أو البخاري أو السليق الذي يقدم مع لحم الضأن، وفي الولائم الأصغر يقدم مع الدجاج كحفلات النجاح، أما في المناسبات الحزينة، فاعتاد الناس أن يأكلوا الرز بالحمص.
لا تخلو الأكلات من تجميل وتذويق عرضها في الأطباق، ولكل أكلة أسلوب وطريقة تقديم توارثته الأجيال، فمثلا السليق يغرف في تباسي كبيرة معدنية تتوسطه قطع اللحم الضاني، ويحاط بشرائح مقطعة من الكبدة، توزع دائريا على أطراف الطبق ويرش عليه السمن الممزوج بنكهة المستكة.
ولكل أكلة ما يرافقها من أطباق جانبية خاصة بها سلطات، مقبلات، حلويات، أما المقبلات فغالبا ما تكون من معجنات متنوعة تحشى باللحم، وتقلى أو تطبخ في الفرن كالسمبوسك والبيف والبريك والسلطات الخضراء، طحينة لبن بالخيار، الدقس الطرشي.. والحلويات الطرمبة والفواكه.
جغرافية المكان
يضيف بلو أن جغرافية المكان لها أيضا ارتباط بنوعية المأكولات، فأهالي الساحل خصوصا في جدة وينبع لهم مائدة بحرية متكاملة تتضمن طبق الصيادية مع أطباق السمك المقلي والمشوي والمحمر في الفرن، وكفتة وشربة السمك والجمبري المقلي وسلطة الحُمر والطحينة والتمر.
ومن الحلويات المرتبطة بالمناسبات ما يقدم في الأفراح، خصوصا صباح الأعياد أو الصبحة التي تلي ليلة الدخلة، ككنافة الموز والزلابية والدبيازة واللقيمات.
اجري هذا اللقاء مع صحيفة الوطن في يوم السبت 20 نوفمبر 2021 – 15 ربيع الثاني 1443 هـ
-
ندوة الاتحاد العربي للمكفوفين بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء

مشاركتي في الندوة التي أقامها الاتحاد العربي للمكفوفين في 2021/10/15م بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء
-
اتفاقية الأدب والنشر ومنشآت وأهميتها للمبدعين من ذوي الإعاقة

نشر هذا المقال على صحيفة الوطن السعودية في يوم الاثنين 27 سبتمبر 2021 – 20 صفر 1443 هـ
في ظل توجهات بلادنا بتنمية قطاع النشر وتحويله إلى صناعة مستدامة وتهيئة بيئة إبداعية وخلق فرص الاستثمار فيه باستحداث هيئة متخصصة في الأدب والنشر والترجمة (فبراير 2020)، وتوقيعها اتفاقية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» (2021/09/08م) بهدف تنمية قطاعات الأدب والنشر والترجمة، وتطوير الكفاءة المالية والتشغيلية ورأس المال البشري.
فلا بد من الإشادة بهذه الخطوة، ومن المؤكد أنه سيكون لها أثر فعّال في تنمية وتطوير دور النشر ودعم المؤلفين السعوديين.
وفي هذا السياق أشير إلى ما يتميز به بعض فئات الأشخاص ذوي الإعاقة من قدرات تعويضية ومواهب إبداعية خصوصًا المكفوفين منهم. فعلى مر العصور انتفع العديد من المجتمعات بإبداعاتهم التي لا تزال آثارها ممتدة حتى اليوم خصوصًا في مجالات الفكر والأدب والفنون، مثل الصحابي «عبدالله ابن أم مكتوم» مؤذن رسول الله ﷺ الذي أنزل فيه الوحي ثلاث مرات ولقب بـ«شهيد القادسية» إثر استشهاده فيها، وشاعر العصر الأموي والعباسي «بشار بن برد» الذي تناقلت الأجيال قصائده وأشعاره على مر العصور، والفيلسوف الأديب «أبو العلاء المعري» صاحب كتاب رسالة الغفران. وفي عصرنا الحديث معجزة الإنسانية الأديبة والناشطة الأمريكية الكفيفة الصماء «هيلين كيلر» التي أبهرت العالم بقدراتها وتُرجمت مؤلفاتها إلى العديد من اللغات، وعميد الأدب العربي «د طه حسين» الذي تقلد العديد من المناصب أعلاها وزير المعارف، وترأس مجمع اللغة العربية بالقاهرة وحصل على شهادتي دكتوراه من جامعتي القاهرة ومونبلييه الفرنسية، بالإضافة إلى العديد من الجوائز العالمية، و«ستيفن هوكينج» أشهر عالم فيزياء نظرية وعلم الكون، الذي شل وهو في الـ21 من عمره نتيجة مرض العصبون الحركي.
وبلادنا كسائر المجتمعات تزخر بالموهوبين والمبدعين من ذوي الإعاقة الذين قدموا إسهامات جليلة، من أبرزهم الشيخ «عبدالعزيز بن باز» -رحمه الله- أبرز علماء وفقهاء العصر الحديث، تقلد العديد من المناصب أهمها مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، والمجمع الفقهي الإسلامي، ونال جائزة الملك فيصل في خدمة الإسلام، وله أكثر من 40 مؤلفا. فضلًا عن العديد من ذوي الإعاقة السعوديين المبدعين في شتى المجالات.
وبالنظر إلى القدرات والمواهب الإبداعية التي يتمتعون بها، وفي ظل الرعاية والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لتنميتهم المستدامة، فإنني أرى أن يكون لهم الأولوية في الانتفاع من تلك الاتفاقية «مشروع ريادة دور النشر» بفتح مسار خاص بهم يسهل وصولهم إليها، ويحصلون بموجبه على منح مالية وقروض ميسرة وبرامج تدريب متخصصة تمكنهم من صناعة محتواهم الفكري ونشره، أو فتح منشآت خاصة بهم تعمل في مجالات الأدب والنشر والترجمة، وفق شروط ومعايير تحددها «الهيئة» و«منشآت» بالعمل والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل استثمار طاقاتهم وقدراتهم التعويضية وإبداعاتهم التي حباهم بها الله ودمجهم في التنمية الاقتصادية. على أن يكون المستهدفون من هم فوق 18 عاما من المسجلين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممن لديهم تخصص أو مواهب إبداعية في مجالات الأدب والنشر والترجمة، بهدف إتاحة الفرصة لهم للإسهام في تنمية وتطوير تلك القطاعات، وفتح مجالات عمل جديدة لهم تلائم ظروفهم الصحية وقدراتهم وخبراتهم العملية وتوظيف مواهبهم الإبداعية، وإيجاد برامج تسهم في الاكتفاء الذاتي والعيش الكريم لأصحاب المواهب الإبداعية من ذوي الإعاقة، علاوة على تسهيل وصول المجتمع وانتفاعه بمواهبهم وإبداعاتهم وإنتاجهم الفكري.
وإنني على يقين بأن تطبيق ذلك سـيكون له دور بارز في اكتشاف وانطلاق العديد من ذوي الإعاقة الموهوبين في مجالات الأدب والفنون خصوصًا الكتابة والتأليف. فلقد كانت لي تجربة شخصية حينما كُرمت من معالي وزير التجارة السابق د. توفيق الربيعة في ملتقى رواد شباب الأعمال (2016/04/08م) بمنحي سجلا تجاريا ومكتبا مجانيا لمدة عام، بصفتي أول كفيف يصدر سجلا تجاريا بمنظومة وزارة التجارة الجديدة، أسست بموجبه منشأة صغيرة ذات مسؤولية محدودة «سطور للنشر». ومنها انطلقت في مجال النشر والكتابة وأصدرت مؤلفي رحلتي عبر السنين، الأديب طاهر زمخشري في سطور. ومارست كتابة المقالات الصحفية رغم التحديات والصعوبات التي واجهتها بحكم إعاقتي البصرية.
يجدر الإشارة إلى أن المعوق يُعرف وفق نظام رعاية المعوقين في المملكة العربية السعودية الصادر في 1421/01/01هـ – 2000/04/06م بموجب المرسوم الملكي رقم م/37 بتاريخ 1421/09/23هـ. هو كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية، إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين.
وإن الإعاقة هي الإصابة بواحدة أو أكثر من الإعاقات الآتية: الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقة العقلية، الإعاقة الجسمية والحركية، صعوبات التعلم، اضطرابات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية والانفعالية، التوحد، الإعاقة المزدوجة والمتعددة، وغيرها من الإعاقات التي تتطلب رعاية خاصة.
وبحسب آخر تقرير للهيئة العامة للإحصاء «مسح ذوي الإعاقة السعوديين 2017) فإن عددهم بلغ (1,445,723) نسمة. منهم (54,430) في الفئة العمرية من 15 -19 عاما. و(1,257,831) من 20 عاما فما فوق. وإن إجمالي الإعاقة البصرية (811,610) نسمة بدرجات متفاوتة، وأن الحالة العملية أو الوظيفية لذوي الإعاقة لمن هم فوق 15 عاما (12,485) صاحب عمل يوظف، (16,342) صاحب عمل لا يوظف، (233,561) مشتغلا بأجر، (5,425) مشتغلا بدون أجر، (29,110) يبحثون عن عمل وسبق لهم العمل، (71,363) يبحثون عن عمل ولم يسبق لهم العمل، (80,295) طالبا، (381,275) متفرغا لأعمال المنزل، (267,611) متقاعدا، (214,794) أخرى.
الرئيسية
عدد المشاهدات 1٬004