قبل أن استكمل قصة إيمان السليماني في جزئها الثاني من هذه السطور المضيئة. التي سأتناول فيها تعليمها المنزلي بعد حرمانها من التعليم المدرسي بسبب ضعف بصرها الشديد.
أشير إلى أنه في تلك الأثناء تصادف اطلاقي لحملة إعلامية بدأتها من صحيفة عكاظ في عددها 10005 (1414/07/11هـ – 1993/12/24م). بعنوان «منح السعودية جائزة عالمية فكافأته بالتَّقاعُد – العمى يُطارد حفيد طاهر زمخشري». وذلك من أجل تسليط الضوء على قضية إدماج ضعيفي البصر في المُجتمع وتأهيلهم. لتولِّي بعض الأعمال التي تتَّفق وقُدراتهم أسوةً بالمُعَوَّقين وفئة المكفوفين منهم بصفة خاصَّة. ولم أكن أدرك حينها أن القضية كانت تتعدى مشكلة فقدان العمل بسبب ضعف البصر. إلى حرمان بعض الأطفال من التعليم المدرسي لذات السبب. الأمر الذي يضطر أسرهم إلى تعليمهم في المنازل. كما حدث مع بطلة قصتنا “إيمان” التي تقول:
تعليمي المنزلي وواقعي المجتمعي
مع مطلع العام الدراسي 1993م. بدأتُ مرحلة جديدة من حياتي بالتعليم المنزلي على يد والدتي. الذي اعتمد على ما تقرأه عليَّ من الكتب المدرسية، ومجلات وقصص الأطفال. وما التقطه وأستوعبه من شقيقتيَّ أثناء مراجعتهما لدروسهما وادائهما لواجباتهما المدرسية. بالإضافة إلى متابعتي لبعض برامج القناة الأولى السعودية التي كان لها دور إضافي كبير في تعليمي وتثقيفي. مثل برنامج «افتح يا سمسم، س و ج، المناهل، العلم والإيمان».
وقد تسبب تعليمي المنزلي في معاناة كبيرة لوالدتي. حيث كانت تضطر للذهاب إلى المكتبة يوميًا لتصوير صفحات الكتب الدراسية وتكبيرها. حتى أستطيع رؤيتها وقراءتها عليها. وما زاد في معاناتها هو عدم توفر أي إرشادات تربوية وأسرية تعينها على التعامل مع حالتي وتعليمي بصورة أفضل.
في تلك الأثناء كنت أعيش حياة مختلفة عن أقراني من أطفال أقاربنا الذين كانوا يزورونا. فعندما يبدؤون في اللعب أتفادى مشاركتهم وانسحب بعيدًا عنهم رغم إصرارهم عليَّ. خصوصًا في الفترات الليلية التي بالكاد أستطيع الرؤية فيها. سيما عندما يركضون وينطنطون في كل مكان ولا أستطيع تتبعهم خوفًا من التعرض لأي حادث. الأمر الذي كان يثير شفقة الكبار عليَّ.
وعندما ينتهون من اللعب نجلس فيتبادلون الحكايات عن يومياتهم في المدرسة مع المعلمات وأقرانهم فيسالونني عن يومياتي المدرسية، فأشعر في داخلي بالحسرة والمرارة أنه لا مدرسة لي ولا معلمة ولا أصدقاء وأخجل من أن أخبرهم بذلك، فأبدأ بسرد حكايات من نسج خيالي عن يومياتي في المدرسة ومواقف عن معلمتي وأقراني من الأطفال، وكانوا يصدقونها ويتفاعلون معها تارة بالضحك وتارة بالتساؤلات حسبما يكون نوع الحكاية، وبمرور الوقت من كثرة ما أقص عليهم من حكايات نمت لدي هواية نسج القصص والحكايات الخيالية.
وأعتقد أن عطف والدَّي ورعايتهما الفائقة لي جعلني أتجاوز ذلك وأتقبل واقعي المجتمعي. حيث كانا يخصصان جل وقتهما لي حتى أصبحت أشعر وكأنني طفلتهما الوحيدة. فقد كانت والدتي مصدر إحساسي بالأمان. فعند خروجنا من المنزل تمسك بيدي ولا تفارقني أبدًا. حتى أصبحت أشعر أنها عينيَّ التي أُبصر بهما. أما والدي فكان مصدر ثقتي بنفسي. حيث كان يشجعني على المشي أمامه بمفردي. وهكذا مثل اثنينهما التوازن ما بين الحرص والرعاية وزرع الثقة بالنفس.
اكتشاف موهبتي الفنية
في غضون ذلك؛ كانت والدتي تمارس يوميًا هواياتها الفنية المختلفة من رسم وأشغال فنية فاجلس بجانبها وأراقب كل ما تفعله. وبدأت أحاول تقليدها فتنامت لدي هواية الرسم، فاهتمت بذلك وبدأت تنميها فيّ، كما لاحظ والدي ذلك فشجعني. ووفر لوالدتي كل ما تحتاجه من مال لشراء أدوات ومستلزمات الرسم (كراسات، أقلام، ألوان). وبدورها هيأت لي كل الظروف لممارسة هوياتي وصقلها.
فبدأت أرسم وأتبع إرشاداتها وتوجيهاتها وأقلد رسمها وأعمالها الفنية باستخدام أقلام الفلو ماستر، وإضاءة إضافية وتقريب وجهي إلى الورقة لتتبع أبعاد الرسمة.

كنت أحاول رسم وجوه الشخصيات الكرتونية من التلفزيون ومجلات الأطفال حسبما أستطيع رؤيته. وكانت رسوماتي تتطور يوما بعد يوم، وإن كنت أعاني كثيرًا فبالكاد أستطيع رؤية ما أرسمه. ومع ذلك كانت رسوماتي جيدة مقارنة بعمري وتطورت كثيرًا، وأيقن الجميع بموهبتي الفنية وأصبحوا يساعدونني ويشجعونني عليها.
وأصبحت محبة للرسم جدًا وأحلم بأن أكبر سريعًا والتحق بالجامعة لأصبح معلمة رسم، ظنًا مني أن الالتحاق بالجامعة يعتمد على العمر وليس على تسلسل المراحل الدراسية، ولم أدرك حينها بإن حرماني من المدرسة سيكون هو العائق الرئيسي لتحقيق حُلمي.

محاولات علاجية يائسة
في غضون ذلك أصبح الشغل الشاغل لوالدَّي هو معالجة بصري بأي وسيلة كانت. خصوصًا والدتي التي ما فتأت عن التنقيب والبحث عن أي حل يمكنني من العودة إلى المدرسة. وتنمية وتطوير موهبتي الفنية. ومواصلة حياتي بصورة طبيعية كباقي الأطفال.
وفي أحد الأيام كانت والدتي تقرأ إحدى المجلات الأسبوعية كعادتها. فصادفتها قصة محامية بريطانية مصابة بضعف بصر شديد كحالتي استطاعت أن تنجح في مسيرتها الدراسية وتصبح أحد أفضل وأشهر المحاميين في بريطانيا باستخدامها أجهزة التكبير الالكترونية للقراءة والكتابة. وظهرت صورتها في المقال وهي جالسه في مكتبها تقرأ ملفاتها من شاشة جهاز المكبر الالكتروني (CCTV) الذي تستخدمه. وعلى الفور اطلعت والدي على القصة وقالت له: لا بد من شراء هذا الجهاز لإيمان مهما كلف الأمر.
وبعد بحث وجهد جهيد تمكن من شراء الجهاز من السويد بكامل اكسسواراته بكلفة تجاوزت الـ 30000ريال. رغم أنه كان مبلغًا باهضًا جدًا في تلك الأيام. وبدأت محاولة استخدامه في القراءة والكتابة والرسم، ولكنه لم يغير الشيء الكثير من معاناتي. فالتكبير لم يناسب بصري لإصابتي بطول نظر إلى جانب التهاب الشبكية الصباغي. فتوقفت عن استخدامه. وأصبح مركونًا كالنظارة والتلسكوب اللذين حصلت عليهما من مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.
وأمام هذا الواقع المرير قرر والديَّ الأخذ بنصائح الأقرباء والأصدقاء باللجوء إلى العلاج الشعبي، والروحي، فكانت البداية بأخذي إلى سيدة عالجتني بقراءات قرآنية وخلطات من الزيوت تدهن بها قدمي ورأسي أثناء القراءة. وفي إحدى الجلسات شلت حركتي تمامًا، ففزعت والدتي من الأمر، فقامت المعالجة بالضغط على قدمي وبعد لحظات استعدت القدرة على الحركة ومن حينها لم نعد إليها ثانية.
عاودنا الكرة مع شيوخ آخرين ومضت أسابيع وشهور ونحن نتنقل من شيخ إلى آخر تباينت آرائهم ووصفاتهم، إذ قال أحدهم إنني مصابة بعين شريرة، ووصف لي آخر الاكتحال بالعسل فجربناه وأصبت بالتهاب وتورم في عينيّ فأُخذت إلى الطبيب الذي شخصني بإصابتي بتلوث بكتيري في العين وكتب لي العلاج اللازم. وحذرنا من اتباع تلك العلاجات والوصفات لضررها وخطورتها على العين.
ولكن حالة اليأس والخوف من إصابتي بالعمى جعل والدَّي يستمران بالبحث فعاودنا الكرة مع شيخ آخر وصف لي ماء الكمأة الذي تسبب لي أيضًا بمضاعفات آلمتني وعولجت منها، وأصبحت أخاف كل تلك العلاجات والوصفات المختلفة، وأخيرًا وُصف لي كحل الاثمد الذي تقبلته لأنه لم يؤلمني أو يضرني ولم ينفعني أيضًا.
وكان من أكثر العلاجات غرابة هو علاج تلك الحاجة المصرية التي جاءت لأداء فريضة الحج وقيل لوالدي بأن لها نظرات مباركة تعالج بها جميع أنواع الأمراض. فأخذوني إليها في جدة حيث كانت تقيم بعد انتهاء موسم الحج. كان مجلسها عبارة عن صالة انتظار للمرضى والغرفة التي تعالج فيها. ويدخل عليها المرضى بالدور. وعندما جاء دوري دخلنا فأجلستني أمامها على الأرض. وبدأت تحملق بعينيها في عينيّ دون أن تنطق بأي كلمة. فأخافتني كثيرًا بنظراتها تلك. وبعد نحو ربع ساعة ضربت على فخذي وقالت لي: قومي وقد شفيتي بإذن الله.
شعر والدَّي بالغبطة والسرور، ودفعا لها الأجر الذي كانت تتقاضاه من كل مريض 500ريال. نظير العلاج بتلك الطريقة. غادرنا والتفاؤل مهيمن عليهما بأني قد شفيت وبصري سيتحسن تدريجيًا كما قالت. وانقضت أيام وأسابيع دون أي نتيجة فأيقنا أن تلك السيدة لم تكن أكثر من مجرد محتالة ودجالة تستغل حاجة الناس.. وتلاشى ذلك التفاؤل والأمل بوجود أي علاج لعينيّ. وهيمن اليأس والحزن عليهما. واستمرت حياتنا كما كانت عليه بالمعاناة التي كنت أعيشها.
مرض والدي ووفاته
في تلك الأثناء شهدت حياتنا تغيرًا جذريًا إلى الأسواء حينما أصيب والدي بمرض الانسداد الرئوي. عانا منه كثيرًا وتفاقمت حالته يوم بيوم على مدى أربعة سنوات حتى أصبح يستخدم الأكسجين الاصطناعي للتنفس. فانشغلت والدتي عني برعايته ومتابعة حالته الصحية. ولم أكن وأخوتي قادرين على تحمل مشاهدة معاناته مع المرض. وانقلبت حياتنا رأسًا على عقب خصوصًا بعدما أصبح قعيد الفراش وبحاجة إلى متابعه صحية على مدار الساعة.
انشغلنا به جميعًا وأصبحنا أسرى مراجعة المستشفيات بين (الطائف- جدة -مكة) التي كنا نضطر لنقله إليها بين الفينة والأخرى. لحاجته للعناية الطبية المركزة. وعندما يتحسن يعود إلى المنزل. وهروبًا من مشاهد آلامه ومعاناة والدتي معه وحزنها عليه شغلت نفسي بالانكباب على الرسم.
وبحلول العام 1421هـ ساءت حالته جدًا وأدخل إلى المستشفى ومكث فيها طويلًا. فشلت حركة البيت تمامًا وزاد قلقنا عليه. وفي رمضان من ذلك العام تحسنت حالته قليلاً فطلب من الطبيب أن يسمح له بمغادرة المستشفى لقضاء شهر رمضان وعيد الفطر معنا. فحاول الطبيب ثنيه عن ذلك حيث كانت حالته تتطلب البقاء في المستشفى لفترة أطول. لكنه أصر ووعد بأنه سيعود بعد العيد فوافق الطبيب على طلبه وسمح له بالخروج نزولًا عند رغبته.
فرحنا بعودته إلى البيت كثيرًا؛ لكن معاناته وحالته الصحية كانت صعبة جدًا. فلم يكن يستطيع الكلام إلا بصعوبة ولا يتنفس إلا بالأكسجين الاصطناعي. وانقضت عدة أيام على هذا الحال. فقررنا ضرورة عودته إلى المستشفى ولكن كان القدر أسرع.
فمع بزوع فجر يوم 21 رمضان حلت الفاجعة الكبرى بوفاته. التي كانت صدمة كبيرة لنا جميعًا واظلمت الدنيا من حولي، فلقد أدركت أني فقدت سندي وصديقي الوحيد الذي كنت ألعب معه ولا يفتأ يشاكسني ويملأ حياتي بهجة ونور. ويوفر لي كل ما احتاجه في هذه الدنيا. وبانتهاء مراسيم العزاء دخلنا في فصل جديد من حياة هيمن عليها الحزن والحرمان.
في تلك الأثناء؛ التي كانت إيمان وأسرتها يعيشون ذلك الفصل الحزين لاح فجر جديد لها ولأقرانها من ضعفاء البصر في عالمنا حينما أسفرت حملتي الإعلامية التي أشرت إليها في مطلع القصة. بإعلان الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله- رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) آنذاك، عن تبني فكرتي لإنشاء مركز لخدمات ذوي الإعاقة البصرية في جدة، في 20 شوال 1421هـ – 16 يناير 2001م بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة مستشفيات ومراكز مغربي، ومباركة الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، ومستشفى العيون بجدة. التي تبلورت لاحقًا في جمعية إبصار الخيرية للتأهيل وخدمات الإعاقة البصرية في 10 رمضان 1424هـ – 05 نوفمبر 2003م. وانطلقت منها إيمان شاقة طريقها لتصبح أحد نجوم الفن التشكيلي في بلادنا.
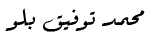

ما شاء الله تبارك الله بالمصاعب تظهر المواهب
قصة صعبة جدا طبعا ده اختصار سنين عمر
بحلوها ومرها مضت على اصحابها ربي يجعله
في ميزان حسناتهم جميعا
قصة ملهمة ومؤثرة
دمت بخير
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله
رب العالمين فعلا عند سماعنا لمثل
هذه القصص تنهز لها مشاعرنا ونتمنى
جميعا ان نقف بدا واحدة ونتكاتف
للمساعدة في مثل هذه المواقف
المؤلمة والمؤثرة لكن أقول ان هذه
المواقف أنجبت رجالا بمعنى الكلمة
رجالا في الافعال والتصرفات ف
منحتهم اصرار وعزبمة على التحمل
والنجاح تحياتي لفنانتنا العظيمة
ايمان واستاذي محمد توفيق بلو
متمنيا لكه جميعا التوفيق والنجاح
واسف على الاطالة اخوكم منير
محمد شيخ دمنهوري
كم تمنيت لو كان بمقدرنا أن نمنح من نحبهم جزء من
عافيتنا او على الاقل نتقاسم معهم تلك الأجزاء
المتبقية منها كما تقاسمنا معهم أيامنا بحلوها
وبالكثير من مرها .
ولكن الأمر مجرد امنيات .