مها عواودة.. معاناة صحفية في لهيب غزة
تلقيت رسالة عبر الواتساب من الإعلامية الأستاذة مها عواودة/السليمان (مراسلة وكالة الأنباء السعودية بالأراضي الفلسطينية المحتلة) مرفقة برابط لتقرير نشرته لها الوكالة في (06 رجب 1445 هـ الموافق 18 يناير 2024) وثقت فيه بالكلمة والصورة قصة نزوحها وأسرتها من منزلها ببيت حانون إلى مخيّمات النزوح.
فحاولت التواصل معها ومراسلتها للاطمئنان على ما آل إليه وضعها بعد رسالتها، ولكن حتى تاريخه حالت ظروف الحرب الوصول إلى أي معلومة عنها.
ورأيت أن من واجبي أن أشارك قرائي الأعزاء قصتها من أجل الدعاء لها ولأهالي غزة بأن ينجيهم الله من الكرب العظيم وينصرهم على أعدائهم من الظالمين.
حيث روت أن رحلة معاناتها بدأت مع نزوحها وأسرتها من منزلها بيت حانون – شمال غزّة في أعقاب السابع من أكتوبر التي انهالت فيها قذائف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومعها بدأت رحلتها بالألم والمعاناة التي تجرعتها كما تجرّعها فلسطينيو القطاع.
وقالت إن القصف كان شديداً، فلم تستطع لملمة أوراقها وجهازها المحمول، وحتى احتياجاتها من الملابس والمقتنيات، واضطرت أنْ تتركهم ورائها. فكان كل همها هو الخروج مع أسرتها بأقصى سرعة من المنزل. ولم تمضِ سويعات حتى أغارت المقاتلات الإسرائيلية على مدينتهم مُدمِّرةً منزلها الذي كان بمثابة مملكتها الجميلة، فأصبح وما أحاطه من منازل أخرى تحت الركام.
وعلى وقع لهيب النيران من قذائف وصواريخ تتساقط هنا وهناك، استطاعت وأسرتها الوصول بلطف الله إلى مخيّم البريج وسط القطاع. فقد كان همها الوحيد هو الوصول مع عائلتها إلى مكان آمن، تحصل فيه على الكهرباء، والإنترنت لمواصلة إرسال تقاريرها إلى وكالة الأنباء السعودية عن تطوّرات العدوان الإسرائيلي.
وبوصف مرعب وأليم قالت: “مكثنا 6 أيام في مخيّم البريج، منتظرين وصول “شبح الموت” الذي كان يلاحقنا ويحسب علينا أنفاسنا، إلى أنْ كانت اللحظة الفاصلة، واستهدف طيران العدو المنزل المجاور لموقعنا، بصلية من الصواريخ، حولته إلى ركام تتصاعد منه ألسنة اللهب، والدخان الأسود، الذي كاد أنْ يفتك بنا جميعاً لولا لطف الله. ورغم أنّنا تحت جنح الظلام، انتقلنا من منزل لآخر على مدار ليل طويل جداً، ظننتُ لوهلة أنّ صبحه لن ينبلج أبداً.. بسبب القصف المدفعي الذي أمطرنا، وأصواته المرعبة التي حبست أنفاسنا كباراً وصغاراً، رافعةً من إيقاع دقات القلوب.. متسائلون: هل سيبزغ الفجر؟!، أم إنّها ليلتنا الأخيرة..”.
لقد ذكرني وصفها ذلك بقول الشاعر:
أسير بليل ليس يدرك صبحة ** وأشباحُ أوهامي حوليَّ حُوما
(طاهر زمخشري – قصيدة وراء الأمل)
لم تنته معاناتها هُنا، بل بزغ الفجر عليها بمعاناة أشد قسوة، حيث كشف طلوع النهار حجم الموت والخراب، وكان عليها التحرّك بسرعة من مخيّم البريج، لكن السؤال إلى أين؟! فلم يكن أمامها وأسرتها إلا التوجّه غرباً نحو مخيّم النصيرات وسط قطاع غزّة، حيث استقر القرار على اللجوء إلى مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كمركز إيواء في المخيم.
وعن ذلك قالت “في مركز الإيواء، كانت المخاطرة لشحن هاتفي النقّال والحصول على الإنترنت من أجل مواصلة عملي الصحفي “مهمة شبه مستحيلة”، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي الذي دمّر معظم شبكات الاتصال في المخيم”.
ولمن لا يعرف ما معنى أن يكون الإنسان صحفيًا وصاحب رسالة، فالصحفي لا يستطيع أن يتخلى عن رسالته ومسؤولياته الإنسانية حتى في أحلك الظروف. وذلك يتجلى لنا فيما تابعت روايته العواودة.. “بعد جُهد محفوف بالمخاطر، وسعي حثيث لامس الموت أحياناً، تمكنتُ من التقاط شبكة إنترنت في مكان بعيد عن مركز الإيواء. برغم تلك الظروف الحالكة والخلل في شبكات الاتصالات والإنترنت، استطعت أخيرًا أن أرسل لوكالة «واس» حصيلة الشهداء والجرحى وما خلفه العدوان من تدمير”.
وبعد ذلك بدأت رحلة المعاناة مع التشرّد والقهر والألم.. قالت عنها لا طعام ولا مياه صالحة للشرب، ولا فراش يركنون إليه في مركز الإيواء، تذوّقوا مرارة النكبة والتشرّد التي عاشها أجدادهم عام 1948.. وبحسب ما ذكرته في وصفها.. “ضجيج الأطفال وصراخ النساء يتعالى في كل مكان.. الجميع يحاول الدخول إلى المدرسة للنجاة من القصف وشظايا الصواريخ.. والصراع من أجل البقاء سيد الموقف، إلى أنْ أُدخلت وأسرتي إلى أحد الصفوف الذي كان للدراسة، وأصبح شاهداً على “رحلة تشرّد” استمرّت لـ 77 يوماً. كانت أياماً ثقيلة، في غرفة تضم أكثر من 50 طفلاً وامرأةً، حيث من المستحيل الحصول على قسط من الراحة وسط دوي القذائف والصواريخ الإسرائيلية وأنين الأطفال، الذين كانوا بالكاد يحصلون على وجبة طعام، إذ كان الحصول على الطعام والشراب “مهمة مستحيلة”، وإنّ حصّلناها فبأسعار خيالية لم نشهدها من قبل أبداً”.
وبلغت المعاناة ذروتها في ذات يوم قالت عنه “تساقطت الصواريخ على بُعد نحو 100 متر فقط من موقع تواجدي، وارتفعت معها سُحُب اللهب الحمراء، والأتربة التي غطت وجوه المارّة، فانعدمت الرؤية، ولم يعد الواحد منّا قادراً على تمييز الشوارع للهروب.. نسمع أصوات الصراخ وتناثر شظايا الصواريخ، فتفقّدتُ نفسي هل نجوت من القصف.. لأيمّم وجهي مُسرعة شطر أحد أزقة المخيّم المؤدية إلى مركز الإيواء.
وكانت مأساة جديدة.. مركز الإيواء، الذي أقيم وأسرتي فيه، تعرض محيطه للقصف، وسيارات الإسعاف في المكان، شهداء على باب المركز.. أطفال يضمدون جراحهم بأيديهم بعدما أصابتهم الشظايا في الرؤوس، فيما ساحة المركز غطّتها مخلفات القصف…
كان همّي الوحيد معرفة مصير عائلتي، فتوجّهتُ إلى “الغرفة الصفية”.. والحمد لله الجميع بخير، ثم تفقدتُ سيارتنا المركونة بالقرب من باب مركز الإيواء، فلم تتضرر كثيراً، اللهم إلا تحطم الزجاج وبعض الأضرار الخفيفة”.
لم ينته المشهد هنا فالقادم اشد ضراوة وقساوة إذ قالت “بعدما اشتد القصف في محيط مركز الإيواء، أصبح من المستحيل البقاء في مخيّم النصيرات، لا سيما في ظل توافد الدبابات الإسرائيلية، واقترابها من المخيّم، كان لا بُدَّ من الرحيل، لا سيما مع اشتداد القصف الإسرائيلي، بعد 77 يوماً من المعاناة والجوع والعطش. توجّهنا جنوباً إلى مدينة رفح، التي تقع في أقصى جنوب قطاع غزّة، في ظل رحلة محفوفة بالمخاطر وبالموت بكل ما للكلمة من معنى، لأن العبور سيكون عبر “شارع الرشيد” على طول الشاطئ الغربي للقطاع، بما يعنيه ذلك من انكشافنا أمام قذائف البوارج الحربية الإسرائيلية الرابضة قبالتنا التي لا تتوقف عن القصف.. ولا يقتصر الأمر على بوارج الاحتلال، بل يُضاف إليها خطر وجود الدبابات الإسرائيلية في وسط مدينة خان يونس، لكن رغم كل ذلك كان لا بد من المخاطرة والخروج من المخيّم، حيث شقّت آليتنا طريقها بما تبقى فيها من وقود، لم يكن متوفّراً أصلاً في قطاع غزّة بسبب استمرار إغلاق المعابر.. أخيراً، وبعد رحلة شاقة قطعنا خلالها نحو 25 كيلومتراً من مخيّم النصيرات حتى مدينة رفح، بدأت رحلة البحث عن خيمة تأوينا في ظل الطقس العاصف والممطر، وبرودة الأجواء التي تنخر العظام.
لكن فشلت كل جهودنا في الحصول على خيمة، فجهزّنا بيتاً من البلاستيك وبعض الأقمشة، بعد جهود ومعاناة كبيرة لتأمين الخشب، لكن حصّلنا البلاستيك وبعض الأقمشة، خاصة أنّ المدينة تؤوي نحو 1.4 مليون نازح، وجميعهم منهمكون في الحصول على مأوى لأطفالهم..
هنا بدأت رحلتنا مع المصير المجهول.. لجوء، معاناة، أمل ضائع، لا ماء ولا كهرباء، نعيش استعادة لنكبة كل الفلسطينيين، بل فصول نكبة جديدة أكثر ألماً، عمّا عاشه الأجداد يوم نكبة 1948.. حلم العودة إلى الوطن أصبح حلماً بخيمة على أنقاض أرض مسلوبة… ومعها تبقى فصول المعاناة تحت سطوة الاحتلال الإسرائيلي مستمرّة”.
ولا أخفيكم قولًا كمْ تأثرت كثيرًا بتلك التفاصيل المريعة التي لا يتخيلها إلا من مر بها، أو ينقلها إليك إنسان تعرفه. فقد عرفت الأستاذة مها عواودة منذ عام عندما أجرت معي لقاءا لصحيفة البلاد السعودية حينما كانت تعمل معهم قبل عودتها لغزة بعنوان «المكفوفون.. تجارب ثرية دعمتها لغة برايل» نشر في (11/06/1444هـ – 03/01/2023م) بمناسبة اليوم العالمي للغة برايل، وبعدها أصبحنا نتبادل المقالات والمنشورات الصحفية.
فأدعو الله لزميلتنا الإعلامية مها وأسرتها النجاة والسلامة ولسائر أهالي القطاع خصوصًا الإعلاميين الذين يواجهون الاستهداف مباشرة أثناء تغطياتهم الميدانية
فالمتابع لأحداث غزة سيلحظ كم الإعلاميين والصحفيين الذين كانوا ضحية هذه الحرب، فوفق إعلان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن عدد القتلى من الصحفيين ارتفع إلى أكثر من 106 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وقالت لجنة حماية الصحفيين الدولية، ومقرها الولايات المتحدة، إن الأسابيع العشرة الأولى من الحرب الإسرائيلية على غزة كانت الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للصحفيين، إذ سُجل مقتل أكبر عدد من الصحفيين خلال عام واحد وفي مكان واحد. وعبرت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء وجود نمط واضح للقصف الإسرائيلي يستهدف الصحفيين وأسرهم.
وقد تابعت شخصيًا تغطية قناة الجزيرة لحادثة استهداف عائلة الإعلامي وائل الدحدوح الذي استشهد معظم أفراد عائلته، ولاحقًا نجاته عندما استهدف مع المصور والمنتج الإخباري لقناة الجزيرة «سامر أبو دقة» الذي استشهد في القصف، وكذلك اغتيال ابنه «حمزة وائل الدحدوح» الذي كان يعمل أيضا مراسلًا لقناة الجزيرة.
وأختم دردشتي هذه بأبيات من قصيدة «من الخيام» للأديب طاهر زمخشري -رحمه الله- الذي وصف فيها حال الفلسطينيين في أعقاب النكبة والنكسة.
الجوعُ يصرُخ فــي البطـونْ والجَرح ينــزف في العيــونْ
واليتــم حاضَنــــــه البنـــــونْ والبؤس يقتحم الحصــــونْ
والناس تُشـــوى فــي أتونْ وبكـــــــل أرض لاجئــــــونْ
فالطفل يصرُخ أين أمي..؟! والأم تهتــــــــــــف يا لَهَميِّ
***
فوق الدروبِ ، وفي الصحارى ، في مغاراتِ السفوحْ
ثَكلــــــــى يمزِّقهــــــا المخــــاض ، ولا تَئِنُّ ولا تبـــــــوحْ
وبكفهـا طفــــلٌ رضيــــــــعٌ ، والثُّديُّ بهـــــــا قُـــــــروح
يبغــي الغِــــذاء ولا غـذاءَ ســـــوى نَفَـــــايات الجـــروح
وأمامهــــا الصبيـــــــــانُ ضَمَتْ من هياكلهم ضُـروح
أغوارُه شُعــــــــل اللهيب ونَفْـثُ هاجــــرهٍ تنــــــــوح
***
لــــم يبـق من زادٍ يُقـــــــات به الأرامــــــل والعــــــيال
وهــمُ عُــــراةٌ يزحفـــــــون من التوجُّــــــع والكَـــــــلال
أجسادهم قِطَـــعٌ لأشــــــلاء تفيــــض بهـــا الرمــال
وعلى شفاههُم اصفــرارُ المـــوت خلَّفــــه السُّــلال
ويتمتمون بِبَحَّةِ المخنــــوق يأمــــل فـــــــي النــــــوال
***
حتـــى المـــروجُ الخضر أجدبَ عُشبُها الزاهي النظيرْ
وتواثبتْ فيهــــا الأفاعـــــي الزاحفــــاتُ مع الهجيـــر
والأُفعوان الفحـــل فـــي شَدِقَيْه زَمْجَـــرةُ السعيــر
فتراكض الرعيــــانُ عن مرعَـــى المواشي ، والغــدير
وتسابقـــــوا والغانيـــــــاتُ لحيثُ يلقـــون المصـــــير
حيث الخيـــــــــامُ الباليــــــــــاتُ وللبــــــــــلاء بها هــدير
***
وَرصـــــاصُ أفَّاكين يهطـــل فوق أدمغةِ العـــذارَى
قــد أطلقــــــوا بالغــــــــدر وَابِلَـــــه، وظنُّـــــوه انتصارا
لم ينسفـــــــــوا بأتونــــــــه إلا الحرَائِـــــر والصغـــــــــارا
والكهـــــــلَ تحملــــه عصـــاه وقد تقوَّس حين سارا
والمرضعـــــاتِ الآمنـــــاتِ مــــع العشيِّ لَـــزِمْنَ دارا
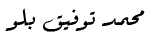

اسأل المولى أن ينصر اخوة لنا في فلسطين وان
بذيق عدوهم الذل والهوان
أسأل الله لها ولجميع اخوتنا في غزة
اللطف والسلامة والفرج العاجل بإذنه تعالى.
انا لله وإنا إليه راجعون.
اللهم لا ناصر لهم الا انت، فعجل بنصرك على
عدوك وعدوهم واجبرهم في مصابهم.
جزاك الله خير الجزاء أبو سندس على هذا النقل
وهذه الدعوات الطيبة المباركة.